الخطبة الأولى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله، نحمده ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلن تجد له وليًّا مرشدًا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا؛ أما بعد:
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران: 102]، ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: 18].
عباد الله، لقد مرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمراحلَ وحِقَبٍ كثيرةٍ، كان من أشقها تلك الحِقبة التي أعقبت وفاة عمِّه أبي طالب وزوجه خديجةَ رضي الله عنها وأرضاها، وكان من نتاج ذلك أن يمَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجهه تجاه الطائف، وهي البلدة القريبة من مكة، الشبيهة بها في تعظيم الأوثان وعبادة غير الله آنذاك.
وهناك في الطائف أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أيام، لم يترك أحدًا من أشرافهم إلا دعاه إلى الإسلام، فتطاولوا عليه وطردوه، ولم يراعوا أعرافهم وتقاليدهم التي طالما زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد تغييرها؛ فلم يراعوا أنه صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى أسرة عريقة ذات نسب عريض وعريق في قريش، كما كانت تراعي ذلك القبائلُ التي كانت تأتي في المواسم إلى مكة، فأغرَوا به سفهاءهم في صورة مقيتة، لا يمكن أن يُقال عنها إلا إنها لؤمٌ خالص وعميق، لا تخلو من مداهنة وتقرب من قريش وأسيادها.
لقد كانت الجراح عميقة في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس زيد بن حارثة رضي الله عنه وهو يدفع الحجارة عنه صلى الله عليه وسلم، ليس لألمِ الحجارة وقسوتها، ولا لأن من يلاحقه هم سَقطُ الناس ورِعاعُهم الذين لا وزنَ لهم ولا قيمة، ولكن بسبب تعامل فجٍّ لا معنى له ولا سبب؛ وصدق الله إذ يقول: ﴿ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الذاريات: 53]، ﴿ أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴾ [الطور: 32]، ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴾ [الأنعام: 112].
إن عَنَتَ الشهوة وسطوةَ الهوى، ومِرْجَلَ الحسد والكبر، والرغبة في استرقاق الناس، كلها حجارة كان يقذفها السفهاء وضعفاء العقول، فتؤزُّهم الشياطين أزًّا، فيندفعون وراء رجل لم يسمعوا منه شيئًا، جاء ليرفع عنهم أغلالًا وبأسًا وذلًّا وهوانًا.
لقد كان منظرًا مؤلمًا غايةَ الألم، والصبيان والعبيد والسقط يقفون صفين يلاحقون النبي صلى الله عليه وسلم أينما ذهب، حتى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع قدمًا ولا يضع أخرى إلا على الحجارة، وسالت الدماء من قدميه الشريفتين، وشُجَّ رأس سيدنا زيد بن حارثة رضي الله عنه، لقد كانوا أشد خِسَّةً ودناءة من كل التوقعات، وأرسلوا إلى قريش من يبلغهم الخبر، ولجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى بستانٍ لبعضِ قريش كانوا مشركين، لكنهم كانوا أكثر مروءةً وشهامةً من هؤلاء، وهناك دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعاءً منه: ((اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكِلُني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدوٍّ ملَّكْتَهُ أمري، لك العُتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك)).
ولجراح المؤمنين عباد الله بلسمٌ يضمدها، وترياق يشفيها، ورحمة تتنزل عليها، كيف والنبي صلى الله عليه وسلم إمام الموحدين وخير الخلق أجمعين، قد كان شديدًا عليه ما جرى وما حصل؛ فجاء (عدَّاسٌ) وهو غلام نصراني من أهل العراق يأخذ قِطفًا من عنب، فيضعه في طبق ويقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له: "كُلْ"، وينظر (عداس) في وجهه الشريف ويسمع لفظةً ما سمعها من أهل الأوثان يسمع: ((بسم الله))، ثم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أرضه، فيخبره أنه من أهل نينوى، فيقول له صلى الله عليه وسلم: ((أمِنْ قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟))، وما هي إلا لحظات حتى تبدلت الحجارة إلى تبجيل واحترام، وإذا بالمشركين يشاهدون غلامهم كابًّا على النبي صلى الله عليه وسلم يُقبِّلُ يديه وقدميه.
لقد أبصر (عداس) ما لم يبصره المشركون، لقد رأى وما عساه رأى، لقد رأى الرحمة المهداة، محمدًا صلى الله عليه وسلم ثابتَ الميثاق حافظه، طيب الأخلاق والشيم، طابت الدنيا ببعثته، جاء بالآيات والحكم، قائمًا لله ذا همم، خاتمًا للرسل كلهم.
وفي أثناء العودة إلى مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم يفكر كيف يدخل مكة، جاءه جبريل عليه السلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فناداني قال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شئت، فناداني فسلَّم عليَّ، فقال: يا محمد، ذلك لك إن شئت أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئًا))؛ وكيف لا يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال الله عنه: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ [الأنبياء: 107]؟ وذلك لِما يتصف به صلى الله عليه وسلم من الحرص على هداية الناس وإنقاذهم من عذاب الله.
وفي طريقه أيضًا صلى الله عليه وسلم تسمع الجنُّ صلاتَه وقراءته للقرآن، فيؤمنون به، أيده الله بالملائكة، ثم بالجن، أولئك الجن الذين عقلوا أمورًا كثيرة بمجرد إيمانهم، وهم من قال: ﴿ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا ﴾ [الجن: 12]؛ أي: علمنا علمَ اليقين أنَّا في قبضته وسلطانه، لن نفوته بهرب ولا غيره، وأنه لا ملجأ منه إلا إليه، وأنا لو أمعَنَّا في الهرب، فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد منا.
هكذا أيها الأخوة أسلم الجن، ونصروا دين الله في وقت كان أكثر البشر فيه ضالين منحرفين، لا يعقلون شيئًا ولا يهتدون.
إن في رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وقفات ولطائف:
منها: أنه ليس أحدٌ أكرمَ على الله من نبيه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أصابه ما أصابه من كرب وبلاء، وعظيم ألم واستخفاف، وتسلط من ضعاف العقول وأرباب الشهوات، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم راضيًا تمامَ الرضا عن ربه، لم يجد عتبًا ولا افتئاتًا في نفسه، وحاشاه صلى الله عليه وسلم، بل كان رحيمًا صابرًا محتسبًا، لم يعطِ الأمر أكثر من دعاء عابر وصلاة ضارعة، ثم بدأ يجهز نفسه للدخول لمعترك جديد؛ لمعترك مكة مرةً أخرى.
ومن العِبَرِ واللطائف أيضًا: أن حظوظ النفس والثأر لها ليس لها مكانٌ عنده صلى الله عليه وسلم، فعندما استسلمت (ثقيف) وخنعت، وجاءت مبايعةً له بعد هذه الحادثة بما يقرب من عشر سنين، يتزعمهم أحد الثلاثة الذين طردوا النبي صلى الله عليه وسلم، لم يتحدث معه صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة قط، ولم يعيِّرْه بأنه أصبح محاصرًا ذليلًا في حصنه، بل أكرمه وأحسن وفادته، وأحسن التفاوض والتحاور معه.
ذلك عباد الله غيضٌ - والله - قليلٌ من فيض كثير، من شخصية عظيمة أنَّى للبشرية بمثلها أو قريب منها؛ وصدق الله: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴾ [القلم: 4]، وصدق الله حين فضله على الأنبياء؛ فقال تعالى: ﴿ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ [النجم: 17]، وصدق الله عز وجل: ﴿ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [التوبة: 128]، سبحان الله! أي إيمان وحكمة وخشية ملأت جنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي مهابة كست وجهه الشريف حتى يراه (عداس) فيكب عليه يقبل يديه ورجليه، وأي صبر أُعطيَه صلى الله عليه وسلم وهو أشرف العرب نسبًا وأعرقهم حسبًا، وأوفرهم مكانًا، وأجملهم وأنضرهم، وهو يرى السفهاء يلاحقونه فيعفو ويصفح.
وصدق الله العظيم إذ يخاطبه صلى الله عليه وسلم فيقول له في ذروة العنت والألم: ﴿ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ * إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴾ [النحل: 127، 128].
أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الخطبة الثانية
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
عباد الله، إن التأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشَغافِ اللُّبِّ، ويجعل المرء يتأمل في شخصيته صلى الله عليه وسلم، وفي معالجته للأمور، وفي عبقريته، وفي صبره، وفي حلمه، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين.
فلئن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج مطارَدًا من الطائف، فقد دخل مكة عزيزًا تحميه سيوف أبناء المطعم بن عدي وصهيل خيولهم، حتى أنه طاف بالكعبة وصلى عندها، وحفظ صلى الله عليه وسلم هذا الجميل، كيف لا وهو يقول يوم بدر يوم الملحمة الكبرى: ((لو كان المطعم حيًّا، ثم كلمني في هؤلاء، لتركتهم له))، نعم، كانت بعد المحنة منحة، والعطاء بعد الابتلاء، فكان الإسراء والمعراج الذي رفع الله فيه رسوله صلى الله عليه وسلم أعلى السماوات السبع، وأوحى إليه خلاله ما أوحى، وأراه من آيات ربه الكبرى، إنها رحلة عظيمة مُلِئت بالدروس والعبر، ولا زال فيها فسحة كبيرة للدارسين والباحثين، وكل بلاء أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو خير وتوفيق وتسديد، وإرشاد لأمته صلى الله عليه وسلم؛ لينهلوا من هذا المنهل العذب، من هذه الأخلاق الرفيعة، وليحمدوا الله على أن شرَّفهم ببعثة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ كما قال يوسف عليه السلام: ﴿ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ [يوسف: 38].
هذا عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه؛ فقال جل من قائل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: 56].
يا رب، صلي وسلم وبارك على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا محمد بن عبدالله، وارضَ اللهم عن الخلفاء المهديين الراشدين: أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وذي النورين عثمان وأبي السبطين علي، وعن باقي العشرة وأهل بدر وأحد، وباقي الصحابة الكرام، والتابعين وتابعيهم بإحسان وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم أعزَّ الإسلام والمسلمين، وأذلَّ الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وأدرِ الدائرة على الكفرة والملاحدة والمنافقين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وانصر عبادك الموحدين في كل مكان يا رب العالمين.
اللهم ارحم المستضعفين من المسلمين، اللهم فرِّج كربهم، ونفِّس همَّهم، واشرح صدورهم، واجعل لهم من كل فرج مخرجًا يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم إله الحق المبين.
اللهم اجعلنا ممن يتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم، ويقتدي به، ويحبه ظاهرًا وباطنًا يا رب العالمين، اللهم وفق وليَّ أمرنا خادم الحرمين لما فيه خير الإسلام وصلاح المسلمين، وفق نائبه يا رب العالمين، وخذ بناصيته للبر والتقوى، ووفقه إلى العمل بما ترضى، وقيِّض له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتدعوه إليه، واصرف عنه بطانة السوء برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفِ مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتاهم يا رب العالمين، ﴿ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ [الصافات: 180 - 182].















 إنتسابي ♡
إنتسابي ♡





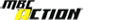
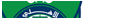



 إنتسابي
إنتسابي 


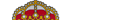





.gif)





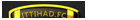

















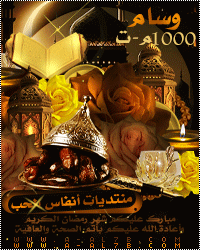


.png) .
.

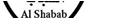




























 العرض العادي
العرض العادي


